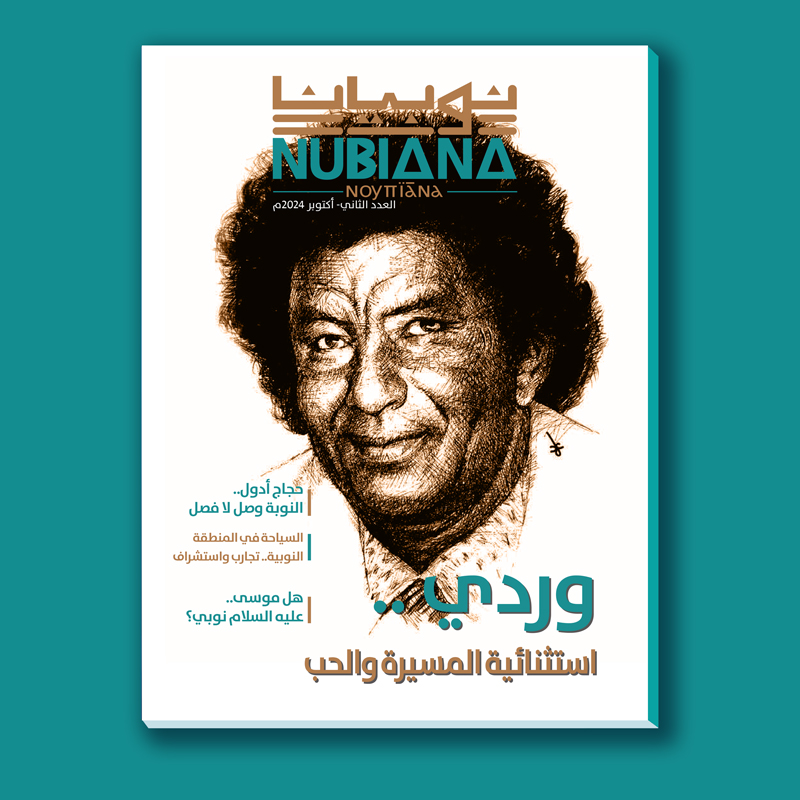أ.د. داود حسين داود سليمان أ.د. فاطمة عبد الرؤوف أحمد
النُّوبيُّون مجموعة من القبائل تعيش في أقصى جنوب مصر، وأقصى شمال السّودان، من قبل الميلاد (3200 -4000 ق. م) وهم، (فاديجا، وكنوز، ومحس، وسكوت، وحلفاويون، ودناقلة)، ويشتهرون بشغفهم بزراعة نخيل التَّمر، وتقديسهم له، وتُعدُّ زراعته في ثقافتهم إرثًا حضاريَّاً مقدَّساً؛ لما لها من أهميَّة اقتصاديَّة واجتماعيَّة وبيئيَّة، وهي مصدَّر للظلِّ، والحفاظ على نسيج البيئة، ودرء مخاطر التصحُّر في مناطقهم؛ ولذلك تميَّزوا بتصنيع المنتجات الغذائيَّة من التمور، بل تفرَّدوا بتخصيص كل صناعة بأصناف أو سلالات معيّنة، مثلاً الصَّنف (غربانة لصناعة المربَّي)، والصّنف (كوري أحمر لصناعة العسل)، والسّلالة (مودة كوري لصناعة المعجّنات)، وقد فقدنا كثيراً من هذه الأصناف بقيام السد العالي، ويقدَّر عدد النخيل المفقود بمليونين، وخمسمئة نخلة، وتحتوي على أصناف وسلالات نادرة، غير أنَّه يوجد منها القليل في مناطق المحس والسِّكُّوت.

ويًعدُّ المجتمع النوبيّ بشكل عام ووفقاً لنشاطه الاقتصاديِّ، مجتمعاً زراعيَّاً يعتمد بشكل رئيسِ على زراعة أشجار النّخيل. وبذلك نجد لها الأثر الكبير في تشكيل الموروث الثقافيّ والاجتماعيِّ لأفراده؛ بل يعتمد كليَّاً على النّخلة. وتشير الدلائل الأثريَّة في المنطقة إلى وجود كثير من هذه الأنماط الثقافيَّة منذ البدايات المبكرة لمملكة نبتة (1500 ق.م – 308 ق.م).
الاستخدام التراثي لأجزاء النَّخيل
النَّخْلَة في المجتمع النّوبيّ رمز للحياة والعمران، وعلامة من علامات الحضارة منذ آلاف السنين؛ لأنَّها تمثِّل العنصرَ الأساسيَّ في الغذاء والكساء والتعمير؛ إضافة إلى أنَّها قد تميَّزت بمزايا عدة جعلت منها رمزاً ثقافيَّاً مستمرَّاً.

إذا أخذنا سعفَ النَّخِيْلْ، نجده قد أصبح جزءاً أصيلاً من معجم التصميمات التشكيليَّة التقليديَّة، إذ تمَّ تصويره على القدور، والأواني الفخاريَّة، ومن أكثر الاستعمالات التشكيليَّة لجريد النَّخِيْلْ أنَّ ملوك النُّوبة يُرْسَمُون على جداريَّات المعابد والمقابر، وأهراماتهم الملوكيَّة، وهم يحملون في أيديهم جريد النَّخْلْ، ولقد توسَّع النُّوبيُّون في استعمال الرمز توسُّعاً كبيراً؛ إذ نراه في صور التتويج، ومناظر المسيرات الملكيَّة، وفي المدافن، وعلى جدران المعابد.
كما أنَّ القصص والأساطير القديمة حفلت بذكر النَّخْلَة؛ بوصفها الشجرة المقدّسة والمباركة، ورمز الخير والخصب، إضافة إلى أنَّه قد اتُّخذ سعفها رمزاً للقدسيَّة، فيُرفع في مناسبات الترحيب والاستقبال، وفي أقواس النَّصر منذ العصور القديمة، وفي كل الديانات السماويَّة اليهوديَّة والمسيحيَّة والإسلاميَّة.


واستُخدم جريد النَّخِيْل في العادات المرتبطة بدورة حياة الإنسان منذ الميلاد، وفي الختان، والزّواج وعند الموت، ففي الميلاد يدفن كيس الولادة (المشيمة والحبل السري) أمام غرفة النَّفَسَاء، ويُغْرَس عليه فرع من جريد النَّخِيْلْ، ويُرْوَى بالماء.
ويَحْمِل العَرِيْسْ في الزواج فرعاً من جَرِيْدْ النَّخِيْل بيده اليُمْنَى، فيما يُعرف بـ (السّيْرَة) قاصدين منزل العروس، ومن ثم إلى النِّيل، كما تُستخدم فروع جَرِيْد النَّخِيْل لتزيين ما يعرف بـالكُوشَة (المكان الذي يجلس فيه العريس والعروس، لحظة الاحتفال بالزواج). تمارس هذه العادة، وهي قطع الجَرِيْد بواسطة أصدقاء العريس، كما تُزيَّن به حجرة العريس في صباح اليوم التَّالي للعُرْس، ويجري تجديده كل صباح مُدَّة سبعة أيَّام.
وفي الختان، يُعْطَى للطِّفْلْ المختون سعفة من جَرِيْدْ الْنَّخِيْلْ؛ ليحمله بيده اليمنى، وتنظّم له سيْرة إلى النِّيْل شبيهة بسيْرة (العريس).
من العادات المتوارثة أيضاً للأطفال منذ ولادتهم ما يعرف بـ (التَحْنِيْكْ)، فبعد مولد الطفل – غالباً قبل أن يتناول أي طعام – يطالب أهله ممن يتوسمون فيه (أو فيها) هدوء الطَّبع، وحسن الخلق والصّلاح والنّجاح أن (يُرَيِّقْ) أو (يُحَنِّكْ) طفلهم؛ وذلك بأن يمضغ الرَّجل المحنِّك تمرة مضغاً جيِّداً، ثمَّ يدخلها في فم الطّفل، ويضغطها على لثته، أو يدلِّكها بها، وقد يكتفي بمسِّ لثَّة الطفل بلسانه، أو بأصبعه السّبابة بعد أن يضعها في فمه أولاً، ويستعمل بعضهم ماء مُسَكَّرَاً أو لبناً بعد أن يقرأ الرَّجل الفاضل عليه بعض التّعاويذ، والناس يربطون، أو يتوسمون أن يُربط مستقبل الطفل بالرَّجل الخيِّر، ويؤملون أن ينتقل ما حباه الله به من خصال حميدة عن طريق الرّيق إلى المولود الجديد.
ومن الموروثات الثّقافيَّة أيضا وما زالت تستخدم بمناطقنا وضع جريد النَّخِيْل على قبر المتوفى.

استخدام النَّخيل في العلاج
تُعدُّ الممارسات الطبيَّة أو الشّعبيَّة التي تُستخدم فيها بعض أجزاء شجرة النَّخْلَة، من أهم الثّقافات المتوارثة؛ إذ تُستعمل حبوب اللِّقاح لعلاج عدَّة أمراض، فمسحوق العذوق يستعمل للتَّخلُّص من التهابات الصَّدر، كما تُنشط حبوب اللّقاح مبايض النّساء اللائي يعانين من خمول المبيض، وترفع القدرة الجنسيَّة للرجال، وتزيد أعداد الحيامن للرجال، وأيضاً تُستعمل في علاج الجروح والحروق والبثور بمزج العسل بحبوب اللِّقا، واستخدام هذا المزيج كمضادات لتغطيَّة سطح الجلد المصاب بجروح، أو حرو، أو بثور، أو أي اعتلالات جلديَّة.
كما يُنقع تمر البَرَكَاوِيْ بماء العطرون، ويقدم شراباً لمريض الملاريا، ويساعد على شفائه.
ويُستخدم النوى بعد معالجته بطرق مختلفة لعلاج عدد من الأمراض منها:
– الرَّمَدْ: يجري تحميص النّوى في النار حتَّى يصير لونه أسود، مثل البن، ثمَّ يُسحق، وتُكحَّل به العين المصابة، ويساعد ذلك على شفائها.
– سُوْسَة الأسنان: تُحرق نواة من التّمر، ومن ثمَّ، توضع على الضرس المصاب بالسُّوسة لكيِّه، ويؤدِّي ذلك إلى قتل سوسة الضرس.
– قطران نوى التمر: يُستخدم القُطْرَان المصنّع من نوى التمر لمداواة عدد من الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان، منها: البواسير، و(القُوْبْ)، وهذه تصيب الإنسان، ومرض الجَرَبْ الذي يصيب الحيوانات.
ويمسح القُطْرَان على الأدوات الجلديَّة كالسَّوْط الذي يصنع من الجلد، أو السِّعِن من جلد الماعز لحفظ المياه؛ وذلك من أجل تطريته، وتليينه للمحافظة عليه.
كما يجري جرش نوى التمر، وخلطه بالذّرة؛ ليقدَّم طعاماً للأبقار والأغنام، ويمتاز بأنه مدرٌّ للألبان، ويزيد من وزن هذه الحيوانات.
عشميق النخيل للحصبة والتنظيف: كما يُنقع عشميق النخيل في الماء مُدَّة ثلاثة أيام، حتى يصير لون الماء أحمر، ويستخدم هذا الماء لعلاج مريض الحصبة بمسحه على البثور، التي تطفح على الجلد. كما يُستخدم ليف النَّخِيْل لنظافة الجسم عند الاستحمام.
دخان وحرارة الكروق علاج وتجميل: يُستخدم دخان الكروق وحرارته (قعور السّعف التي تترك على ساق النخلة) لمرضى الرطوبة، وذلك بتعريض الجزء المصاب من الجسم لدخان وحرارة الكَرّوْقْ، ويساعد ذلك على شفاء المريض من الرطوبة، كما تستعمل النّساء هذا الدخان في تثبيت الحناء التي تستخدم للزِّينة، حيث يُحِيْل دُخَان (الكَرّوْقْ) لون الحناء إلى اللون الأسود الدَّاكن.
سعف النَّخِيْل لتجبير الكسور: يُستخدم سعف النَّخِيْل لتجبير الكسور بعمل ما يعرف بـ (الطَّاب)، وهو مجموعة من قطع جريد النخيل، ومقياس القطعة قدم، إذ يجري طي الجزء المصاب بالكسر من جسم الإنسان بقطعة من القماش، ورصف مجموعة قطع الجريد حول هذا الجزء بوضع طولي لتأخذ الشّكل الأسطوانيِّ، ثمَّ ربطها، والغرض منها تثبيت الجزء المكسور في وضع مستقيم حتى يجري جبره وشفاؤه.
خوص النّخيل: يداوى بخوص النخيل (الفَكَكْ)، أي الفصل، الذي يصيب دائماً مفاصل أصابع القدم؛ إذ يحدث في بعض الأحيان أن ينزلق شخص بقدمه، ويؤدِي ذلك إلى حدوث فصل في مفاصل أصابع القدم، وتكون مداواته بعمل ضفيرة من السعف حول القدم، ووظيفتها شدُّ الجزء المفصول، وإرجاعه إلى وضعه الطبيعي، بعد جفافها؛ إذ تُتْرك هذه الضفيرة في القدم مُدَّة يومين، وكلما جفَّ سعفها في القدم تَشْتَدُّ، وبذلك يعود الجزء المفصول إلى وضعه الطبيعيّ.

استخدام التمور غذاءً
قراصــة التمر: تُحمص قطع التَّمر المكسَّرة، وتُخلط جيداً مع عجينة دقيق من القمح، والمخلوط بدقيق الذرة المخمّر، وقليل من المنكهات، مثل: القرفة أو الهبهان.
– العصائر:
البقنيَّة: عصير تمر مركز من عجين التَّمر، بإضافة ذرة رفيعة (مزرَّعة)، تُهرس ِجيِّداً بالأيدي، ويخفف حتى يصبح مشروباً جميلاً يعرف بالعسليَّة أو البقنيَّة.
الشـُربوت: تبدأ عمليَّة تصنيع الشربوت من تخمير نقيع التمر (عصير التَّمر) مُدَّة 12ساعة مع بعض البهارات (قرفة وجنزبيل وقرنجان) بواسطة الخميرة الطبيعيَّة، مع إضافة التوابل لإعطاء النَّكهة المميَّزة، وللتحكُّم في درجة التخمُّر. يجري تناوله بكميّات كبيرة في المناسبات الدينيَّة، والاجتماعيَّة.
صناعة العرقي: تُعدُّ صناعة الكحول من التمور النّوبيَّة صناعة تقليديَّة، ويسمي (عرقي البلح).
4- مديــدة التَّمــر أو عصيدة التَّمر: كلمة مديدة أصلاً من القاموس الُّنوبيِّ، وتعني مخلوطاً من عجينة التَّمر مع الدقيق (القمح/الشعير/الدخن)، وبناءً على نسبة المكوِّن تختلف أسماؤها بين عصيدة التَّمر ومديدة التَّمر (إذ يكثر مكوِّن الدقيق في العصيدة، على حساب مكوِّن التَّمر، والعكس صحيح، إذ يزيد مكوِّن التَّمر على حساب مكوِّن الدقيق).
5- البربور: كلمة البربور أصلاً من القاموس النُّوبي، ومنها جاءت كلمة بربور إلى العربيَّة، وهي طهي عجينة التَّمر مع قليل من السَّمن البلدي، وتؤكل بغمس قطع الخبز المقلي، والمصنَّع من دقيق القمح أو الشعير.
6 – صناعة المربَّى: تميّز النُّوبيُّون في صناعة مربى التًّمر تقليديَّاً؛ بعزل التَّمر الأكثر نضجاً من الأصناف والسلالات التي يفضل تصنيع المُربَّى منها، ويوضع لب الثمار في إناء خزفيِّ تحت الشَّمس مباشرة مُدَّة شهر تقريباً، ولإطالة فترة حفظها، ولتكثيف قوامها يغمس فيها ثمار الصنف (غربانة) كاملة، بعد نزع النوى والقمع، ويمكن إضافة قليل من القرفة أو الهبهان كمنكهات.

بعض أصناف التُّمور النوبيَّة
1- من أهم أصناف التُّمور الـ (بركاوي Brakawi)، وكلمة بركاوي باللغة النُّوبيَّة Ebettai، ومعناها باللُّغة العربيَّة بركة، ومنها جاءت كلمة بركاوي، وذلك لتميُّزها بالحمل الغزير، ويقال لها باللُّغة النّوبيَّة (Ebitfenti)؛ إذ كلمة fenti معناها باللُّغة النّوبيَّة تمر، وبذلك تعني التَّمرة المبروكة .
2- تؤكد كل الموروثات الثقافيَّة في التاريخ والأدب النوبيِّ أنَّ الصنف بتمودة أو (ابتي مودة / Ebty Moda) تُعدُّ سلالة أو طفرة من البركاوي Ebettai Moda أي طراز جيني جديد من البركاوي؛ ولذلك جاءت كلمة Ebty Moada بالإنجليزيَّة، وتعرف الـ (ابتي مودة) أيضًا في المنطقة النُّوبيَّة بتمرة الضيوف، أي تعني كلمة إسكتن فنتي بالنوبي ضيوف (إسكتن فنتي Ebettai Iskitta )
3- من التمور المهمَّة جدَّاً الصنف (قنديلة) Gondiala والتي تعرف في اللغة النُّوبيَّة باسم أقوندينا (Agondaina)، وأيضاً تعرف أحياناً في معظم مناطق الشايقيَّة باسم (قندولا).
4- الصنف (غربانة) Garbana، وتعرف هذه الثمرة بأنَّها شديدة الشبه بثمرة المجهول، وتُعدُّ من التمور الراقية جدَّاً، التي تُقدَّم للضيوف (أسكتن فنتي)، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات؛ لتقييمها، وإكثارها.
5- صنف كُلْمَة وباللُّغة النُّوبيَّة ( Kolma)، ومعناها باللُّغة النوبيَّة ضخمة الحجم، سميكة اللب، (وتكتب Kulum بالإنجليزيَّة)، وتوجد منه سلالات عدَّة:
أ- كلمة بيضاء: وباللغة النوبيَّة Koolma nulwa وبالإنجليزية (biada Kulum)، وتفضل في صناعة المربَّى. وهي أيضاً من التمور الفاخرة، التي تُقدَّم للضيوف (إسكتن فنتي).
ب- كلمة سوداء: وبالنوبي Koolma oroom، ومعناها بالنوبيِّ الضخمة السوداء، وبالإنجليزية (Kulum swada).
ت- كلمة عجوة: وبالنوبيِّ (Koolma agwa)، وبالإنجليزيَّة (Kulum agwa).
6- الصنف كورَي: وكلمة (Kooray) باللّغة النّوبيَّة تعني عجوة، وتكتب بالإنجليزيَّة (Kooray)، أيضاً لها سلالات عدَّة، موجود القليل منها في منطقة المحس (جوقل)، ويتميَّز الصنف كوري هذا بأنَّه يؤكل رطباً، وهو من التمور الفاخرة، التي تُقدَّم للضيوف (إسكتن فنتي)، ومن السلالات الموجودة في منطقة المحس:
كوري أبيض: باللُّغة النوبيَّة (Kooray nulwa)، وnulwa تعني أبيض. وتفضَّل في صناعة المُربَّى.
كوري أحمر: باللُّغة النّوبيَّة (Kooray gaila)، وتعني كلمة gaila أحمر، وتفضَّل في صناعة العسل.
مودة كوري: باللُّغة النُّوبيَّة (Moada Kooray)، وتعني طرازاً جينيَّاً جديداً مختلفاً عن بقيَّة سلالات الكوري، وتمتاز منها بغزارة حملها، وثمرتها مَقرَشة، وأكثر حلاوة، وأقل (تانين)، وأقل أليافاً؛ ولذلك تفضَّل بشدَّة؛ بوصفها ثمرة مائدة، وجيِّدة في تصنيع المخبوزات الراقيَّة، والعسل، والمربات.

7- الصنف قيلادة (Gailada): وتعني بالنُّوبيَّة أحمر عقيقي زاهٍ، وهي ثمرة كبيرة الحجم، وشديدة الشبه بالزغلول، وتوجد منها أربع سلالات تختلف في مورفولجي السَّعف، والعذوق، وعموماً تتشابه ثمارها في أنَّها مَقرَشة، ونسبة السُّكر للألياف عاليَّة جدَّاً، مما يؤهِّلها لتكون تمرة مائدة، وتصنيع، وتختلف في لون الثمار والعذوق، ولا توجد هذه السلالات إلَّا في منطقة السِّكُّوت (حَميد)، والسلالات هي:
أ- G.foady: اسم نوبيٌّ يعني قيلادة حمراء أرجوانية.
ب- G. toorshi: اسم نوبيٌّ يعني قيلادة حمراء غامقة.
ج- G.parshi: اسم نوبيّ يعني قيلادة حمراء كستنائية.
د- masoonkale .G: اسم نوبيٌّ يعني قيلادة حمراء قرمزيَّة، وكلمة (Masoonkale ) تعني بالنوبيّ الجمال المطلق.
8- الصنف قرقودة (Grargoada): وموجودة في منطقة المحس، وتسمّى في مناطق أخرى من السّودان (ترقوة أو البورة).
9- الصنف دقنة (Dogona): وتُسمى في مناطق أخرى من السُّودان (العبد رحيم) وتستعمل كثيراً في صناعات المشروبات (الشربوت والعرقي).
10- الصنف أوشى كمندينا (Oshikamandina): ولا توجد إلا في منطقة المحس، (وتعني كلمة أوشي باللغة النوبيَّة زنجي، وكلمة كمندينا تعني الشُّرطي أو العسكريّ، أي تمرة الشرطيِّ الزنجيِّ.
11- الصنف شدة (Shida): ويوجد كثير منها في منطقة المحس، وتستعمل في صناعات المشروبات.
12- الصنف شانادة (Shanada): موجود في منطقة المحس والسِّكُّوت، ويُستخدم في صناعات غذائيَّة عدَّة.
13- الصنف سكار (Sakar): لا يوجد إلَّا في منطقة السِّكُّوت (قبة سليم)، تُفضَّل بشدَّة بوصفها ثمرة مائدة، وجيِّدة في تصنيع المخبوزات الراقية.
14- الجاو (Jaw): وهي كلمة نوبيَّة يقصد بها أي نخلة نشأت من النّوى (أي مجموعة سلالات بذريَّة مختلفة الأشكال والأحجام)، وتوجد(148) سلالة مختلفة من الجاو في منطقة المحس، وتسمي بألوانها أو أصحابها، وأهم سلالتين انتشاراً:
أ- السلالة (Jaw nulwa)، وتعني بالنُوبيَّة الجاو الأبيض (Jaw Abiad).
ب- السلالة (Jaw gaily): وتعني بالنُّوبيَّة الجاو الأحمر(Jaw Ahmer).
وتستعمل في الصناعات التغذويَّة المختلفة كمادة مالئة، ومعجَّنات، وعصائر، ومشروبات روحيَّة.
ومن الثقافات الموروثة لدى النوبيين ثقافة الميتازنيا، وهي أثر حبوب اللقاح في جودة محصول التَّمر، ويعرف فحل التمر باللُّغة النُّوبيَّة AdMondi، أي Date palm Male of، كأن لديهم عدداً من الأفحل مخصَّص للإناث المختلفة من الأصناف.

الاستخدام التراثي لمخلَّفات النَّخيل
قديماً وقبل انتشار مضخات (طلمبات) لسحب المياه كانت الساقيَّة و(الشادوف) من أهم وسائل الرَّي، وكانت معظم مكوِّناتها تصنع من أجزاء النَّخيل، وأليافه.
صناعة الخوص التراثيَّة
الخوص هو أوراق سعف النَّخيل، يجمع ويصنَّع باليد (ظفيرة) عريضة تضيق أو تتسع باختلاف الإنتاج، ويتشابك الخوص مع بعضه في الجديلة، بعد أن يتحوَّل لونها إلى الأبيض نتيجة تعرضها للشمس، ويجري تشكيل المنتوج باستخدام إبرة عريضة وطويلة، وخيط قد يكون من الصوف، ويُصبغ الخوص بغلي ماءٍ في وعاء كبير توضع فيه الصبغة المطلوبة، كالأخضر والعنابي والبنفسجي، وغيرها ويوضع الخوص مُدَّة خمس دقائق في الماء، ثم يوضع في الظلِّ، أما الخوص الأبيض، فإنه يكتسب لونه نتيجة تعرضه للشمس.
——————-
المراجع:
1- بروفيسور داود حسين داود، وبروفيسور إبراهيم الجبوري، ود. ثائر يس، الممارسات المستدامة لتحسين سلسلة قيمة نخيل التَّمر في السودان، مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتَّحدة (الفاو FAO)، 2024م.
2- بروفيسور داود حسين داود، وبروفيسور فاطمة عبد الرؤوف أحمد، زراعة التمور وإنتاج النَّخيل في السّودان، أبو ظبي: مطبوعات جائزة خليفة لنخيل التمر، الإمارات العربيَّة المتحدة.
3- بروفيسور فاطمة عبد الرؤوف أحمد وبروفيسور داود حسين داود، نشرة إرشاديَّة عن منتجات النخيل، من منشورات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتَّحدة (الفاو FAO)،2020م.